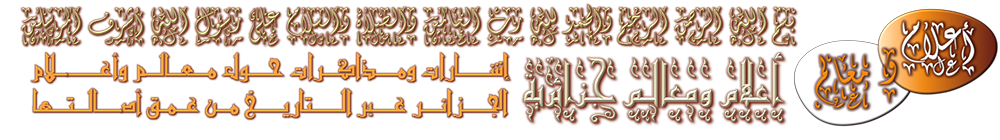الإصلاح الديني
كثيرا ما يتشدّق مدّعوا العلمانيّة في أوطاننا الإسلاميّة بضرورة الإصلاح الدّيني على الطّريقة الأوروبيّة حتّى نتمكّن من الحضارة والتّقدّم والرّقيّ، وأنّ سبب تخلّفّنا هو الإسلام الرّجعي في زعمهم. والقارئ المنصف للتّاريخ لا يمكن أن يلاحظ فروقا جوهريّة بين حضارتنا والحضارة الأوروبيّة من جهة وبين الإسلام والمسيحيّة من جهة أخرى. فروقا تجعل كلّ إسقاط لآليّة النّهضة الأوروبيّة على النّهضة في بلداننا الإسلاميّة سفها وشططا ومآلها الفشل الذّريع المحتوم. من هذه الفروق نذكر هذه العناوين:
- الإسلام ليس دينا نخبويّا كما هو حال المسيحيّة الّتي غطّت أوروبا بالجهالة والظّلام لأكثر من عشر قرون. فالمسلم رجل دين بطبعه مطلوب منه شرعا التّفقّه في أمور دينه ودنياه ولا يرجع لعلماء الشّريعة إلّا فيما يشكل عليه من مسائل الخلاف. أمّا المسيحيّ فهو رجل دنيا ورجال دينهم وكلاء يقومون مقامهم حتّى في الغفران عن الخطيئة! وهذا ما جعل الأوروبيّين يثورون على الكنيسة التي طغت واستعبدت النّاس باسم الدّين وجعلت الدّين حكرا عليها لا ينازعها فيه أحد. أمّا عندنا، فيحقّ لكلّ واحد من المسلمين أن يقرأ ويدرس ويتعلّم ويجادل العلماء بالحجّة والفكرة ويستفسر ويطلب الدّليل والبرهان.
- الإسلام كان سببا في إنشاء حضارتنا، فالدّعوة المحمّديّة أرست قواعد في العبادات والمعاملات والأخلاق والمجتمع ففتحت بلدانا وأمصارا وشيّدت عمرانا وأنشأت مجتمعا راقيا وعلوما أنارت البشريّة. أما المسيحيّة فقد كانت سببا في دخول أوروبّا إلى ظلام دامس دام قرونا. فلا عجب أن ترتبط فكرة التّطور عندهم بنقض عُرى الدّين.
- المسيحيّة احتكرت المعرفة على أتباعها وتفسير الدّين لنفسها لدرجة أن جرّمت القراءة والكتابة وأحرقت الكتب ومجّدت أميّة العبيد. أمّا الإسلام فقد حثّ على القراءة والكتابة والعلم، وكان فخر الأمّة أن تعمُر كتاتيبها بالصّبيان ذكورا وإناثا طلبا للعلم. حتّى أنّه وقبيل الاستدمار الغاشم للجزائر بأعوام، كان الرّحالة الأوروبيّون مبهورين بمعرفة النّاس رجالا ونساءا للقراءة والكتابة على عكس ما كان في أوروبا حتّى بعد قرون من بداية نهضتها. أمّا نهضة الأمّة الإسلاميّة فكانت بكلمة اقرأ من أول يوم!
ويأتي المتنطّعون والمتفيقهون ليقرن الإسلام دين الحقّ والعلم والفكر بمسيحيّة محرّفة أساسها الجهل والأمّيّة واحتكار الفكرة.
التصنيفات:
قراءات في التاريخ
المكان:
وهران، الجزائر
الخمول الحضاري
 عند مطالعتنا للتّاريخ الأوروبيّ في عصر النّهضة الصّناعيّة، نجد حال الشّعوب الأوروبيّة لا يختلف كثيرا عن حال شعوبنا الإسلاميّة في نفس الفترة، إن لم يكن أسوأ.. فرغم الاختراعات والطّفرات الصّناعيّة والآليّة آنذاك، إلّا أنّ الشّعوب الأوروبيّة كانت تحت نير الاستبداد والاستعباد والفقر والجهل والأمّيّة.. أمّا شعوبنا، وإن كانت تحت الفقر والاستبداد، إلاّ أنّها لم تكن بهذا السّوء من ناحية العلم، بل كانت الأمّيّة شبه منعدمة عند الذّكور والإناث على السواء..
عند مطالعتنا للتّاريخ الأوروبيّ في عصر النّهضة الصّناعيّة، نجد حال الشّعوب الأوروبيّة لا يختلف كثيرا عن حال شعوبنا الإسلاميّة في نفس الفترة، إن لم يكن أسوأ.. فرغم الاختراعات والطّفرات الصّناعيّة والآليّة آنذاك، إلّا أنّ الشّعوب الأوروبيّة كانت تحت نير الاستبداد والاستعباد والفقر والجهل والأمّيّة.. أمّا شعوبنا، وإن كانت تحت الفقر والاستبداد، إلاّ أنّها لم تكن بهذا السّوء من ناحية العلم، بل كانت الأمّيّة شبه منعدمة عند الذّكور والإناث على السواء..أمّا الآلات والاختراعت، فرغم استبداد وفساد الأنظمة عندنا، والّذي لم يبلغ فساد الأنظمة الأوروبيّة وقمعها وجرائمها، فقد عملت هذه الأنظمة على الأخذ بهذه الاختراعات كالكهرباء وآلات النّسيج والمصانع ولو على استحياء، ولو بنوع من التّأخّر أو التّأخير..
وإن كان الحال كما هو مذكور، فكيف صارت الأمور بعد ذلك على النّحو المشين الّذي نعرفه؟ وكيف احتلّت هذه الشّعوب الأمّيّة تلك الشّعوب الّتي تحسن القراءة والكتابة؟ وكيف حكمنا شذّاذ الآفاق على علمنا؟
والحقيقة أنّ الجواب عن هذا السّؤال ليس بالأمر الهيّن، وقد خاض المؤرّخون في كثير من جوانبه الفنّيّة والاقتصاديّة والأخلاقيّة.. ولكنّ الجواب الذي يلّخّص كلّ تلك الجوانب هو ما أفنى فيه مفكّرنا مالك بن نبي حياته.. إنّها دورة الحضارة..
لقد كانت تلك الشّعوب الأمّيّة على جهلها وسوء أخلاقها، في حالة فوران حضاري، طامعة للتّسيّد والتّمدّد.. فيما كنّا نحن في حالة من الخمول الحضاري، راضين بما نحن عليه، نقتات على نشوة حضارة أفلت ولم يبق لها من الوجود إلا أضغاث أحلام بلا باعث على الحياة..
هذا الخمول الحضاري، جعلنا لعدّة قرون نعاني ويلات استدمار من شذّاذ آفاق وأمّيّين وجهلة، رغم علمنا ومعرفتنا ورصيدنا..
هذا الخمول الحضاري الذي جعل هذا المستدمر ينتزع منّا جيلا بعد جيل اعتزازنا بأنفسنا وعلمنا ومعرفتنا ورصيدنا، حتّى ظهر من بين ظهرانينا من يسبّ حضارتنا وتاريخنا ولغتنا ويدين بالولاء للمستدمر الجاهل الأمّيّ الأفّاق..
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)